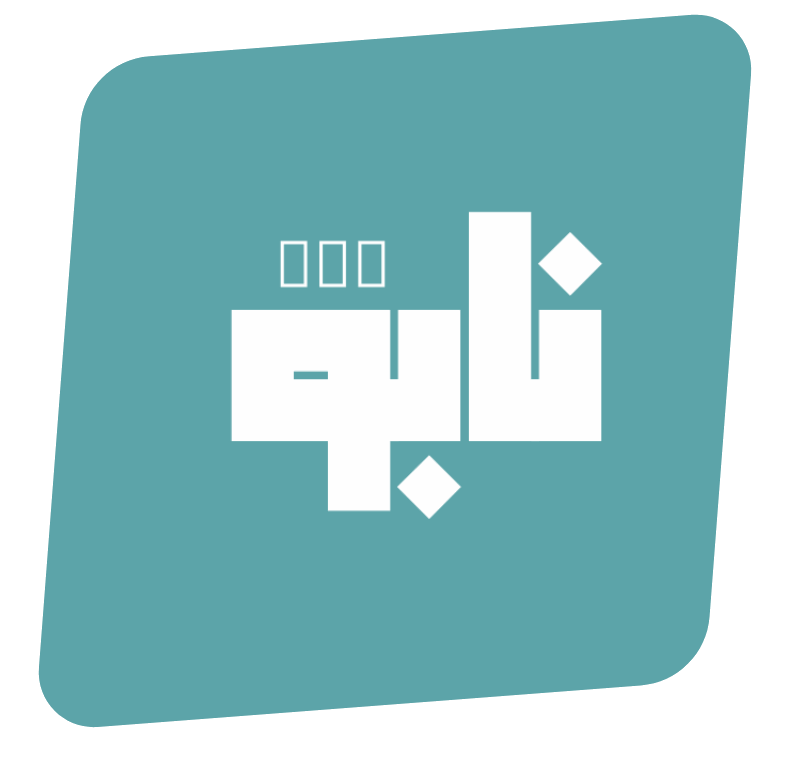محمد الكلابي
في زمنٍ صار فيه الطريق إلى البرلمان أقصر من طريق الفهم، وصار من يجيد تقليد الأصوات أكثر حظّاً ممن يجيد قراءة القوانين، لم يعد غريباً أن يظهر بين المرشحين من كان قبل أسابيع يفتح بثّاً مباشراً على “تيك توك” يقلّد أصوات الفتيات ويتبادل المزاح مع المراهقين، فإذا به اليوم يتحدث عن “الإصلاح” و“خدمة الوطن”. هذه المفارقة ليست نكتة سياسية عابرة، بل مرآة لوطنٍ بدأت تتبدّل فيه معايير الجدارة: من الفكرة إلى الصورة، ومن الكفاءة إلى الظهور، ومن الخطاب إلى الأداء.
السياسة، التي كانت في جوهرها فعلاً معرفياً ومشروعاً للتنظيم والإصلاح، انزلقت شيئاً فشيئاً إلى ميدانٍ من الاستعراض العام. لم تعد ساحتها للعقول، بل للمؤثرين. صار الخطاب الانتخابي يُكتب بلغة السوق، ويُدار بعقلية الإعلان التجاري. الأحزاب لم تعد مؤسسات تفكيرٍ ومراجعة، بل شركات توزيعٍ جماهيري، تبحث عن “وجه مألوف” يجذب الانتباه أكثر مما تبحث عن عقلٍ يُنضج القرار. هكذا أُفرغت السياسة من معناها لتصبح وظيفة في “اقتصاد الانتباه” لا في إدارة الدولة.
والفن، الذي يُفترض أن يكون ضمير الأمة، يُستدرج اليوم إلى لعبةٍ لا تليق برسالته. فحين يتحول الفنان من ناقلٍ للوجدان إلى متسلقٍ للمناصب، يفقد الفن روحه قبل أن يفقد السياسة معناها. الفن الحقيقي لا يحتاج إلى كرسيٍّ نيابي ليثبت تأثيره؛ يكفيه أن يحرك الوعي. أما حين يُستعمل الفن كدرعٍ زائفٍ لغياب الفكر، يصبح دخوله إلى البرلمان ضرباً من العبث الرمزي. فالمشكلة ليست في الفنان الذي يترشح، بل في الفنان الذي لا يحمل ما يترشّح به.
إنّ هذا المشهد يكشف ما هو أعمق من الأزمة السياسية: أزمة وعيٍ جمعيٍّ تخلّى عن المعايير واستبدل بها المظاهر. المجتمع الذي يُساق بالترندات لا بالتصورات، ويصوّت لمن يشبهه في اللهجة لا في الرؤية، يختار في النهاية مرآته لا ممثله. وهذه هي الكارثة: أن تتحول الانتخابات إلى اختبارٍ في “الألفة الشكلية” بدل “الجدارة الفكرية”، فيُنتخب مَن يُرضي الذوق لا مَن يُصلح الواقع. إنها ليست انتخابات وطن، بل إعادة إنتاجٍ للفراغ بلغةٍ جديدة.
حين تُصبح الدولة امتداداً للمنصّة، يفقد القرار وزنه، ويصبح الرأي العام فريسةً لاقتصاد التفاعل. فالمؤثر الذي يجيد إدارة الإعجابات لن يجيد إدارة الموازنات، والذي يعرف كيف يصنع ضجةً في دقيقة، لن يعرف كيف يصنع خطةً في عام. وأشدّ ما يعبّر عن هذا الانهيار أن يظهر أحد المرشحين على شاشة تلفزيونية، فيسأله المذيع ببساطة: “كم عدد أعضاء البرلمان العراقي؟” — فلا يعرف ويتلعثم أمام الكاميرا. مشهدٌ صغير لكنه يختصر المأساة: فبينما كانت المعرفة يوماً شرطاً للنيابة، صارت اليوم استثناءً في من يطلبها. إنّ استبدال الكفاءة بالشهرة ليس فقط خطأً سياسيّاً، بل خيانة لمفهوم الدولة نفسها؛ لأن السلطة التي تُمنح لمن يجيد الترفيه تفقد هيبتها وتتحوّل إلى أداة لهوٍ جماعي.
الأحزاب التي تروّج لهذه النماذج تعرف تماماً ما تفعل. إنها لا تراهن على وعي المواطن بل على ضعفه، لا تستدعي طاقته بل سذاجته. هكذا يكتمل المشهد: مرشّح بلا فكر، حزب بلا رؤية، وجمهور بلا مقاومة. وما يُسمّى بـ“الديمقراطية” يتحول إلى طقسٍ لتجميل الجهل، وإلى احتفالٍ رمزيٍّ بانهيار القيمة.
وهذا يُذكّرني بمقطعٍ شعريٍ للمعرّي، كأنّه كُتب لنا اليوم:
يَسوسونَ الأُمورَ بغيرِ عقلٍ
فَيَنفُذُ أَمرُهُم وَيُقالُ ساسَه
فَأُفَّ مِنَ الحَياةِ وَأُفَّ مِنّي
وَمِن زَمَنٍ رِئاسَتُهُ خَساسَه
فالسياسة ليست منصة بثٍّ مباشر، ولا تجربة مهنية تُضاف إلى السيرة، بل امتحانٌ للوعي ومسؤولية أمام التاريخ. من أراد دخولها فعليه أن يعرف أن الشهرة لا تُنقذ وطناً، وأن الضوء الذي يصعد به قد يحرقه إن لم يكن في داخله فكرٌ يحميه. إنّ الوطن لا يحتاج إلى من يجيد الظهور، بل إلى من يحتمل العمق، ولا يطلب من ممثليه أن يكونوا محبوبين، بل أن يكونوا جديرين.
وحين يصل إلى البرلمان من كان بالأمس يملأ الشاشات بالمقالب، فإن السؤال لم يعد عن هؤلاء، بل عن مجتمعٍ سمح لهم أن يصبحوا صورته. في تلك اللحظة لا يكون الخطر في من يترشّح، بل في من يصوّت. لأن سقوط المعنى لا يحدث في الكواليس، بل في الصندوق ذاته. وهناك فقط، تتجلّى المأساة كاملة: شعبٌ ينتخب ضجيجه، ودولةٌ تتحدّث بأصواتٍ لا تعرف ماذا تقول.