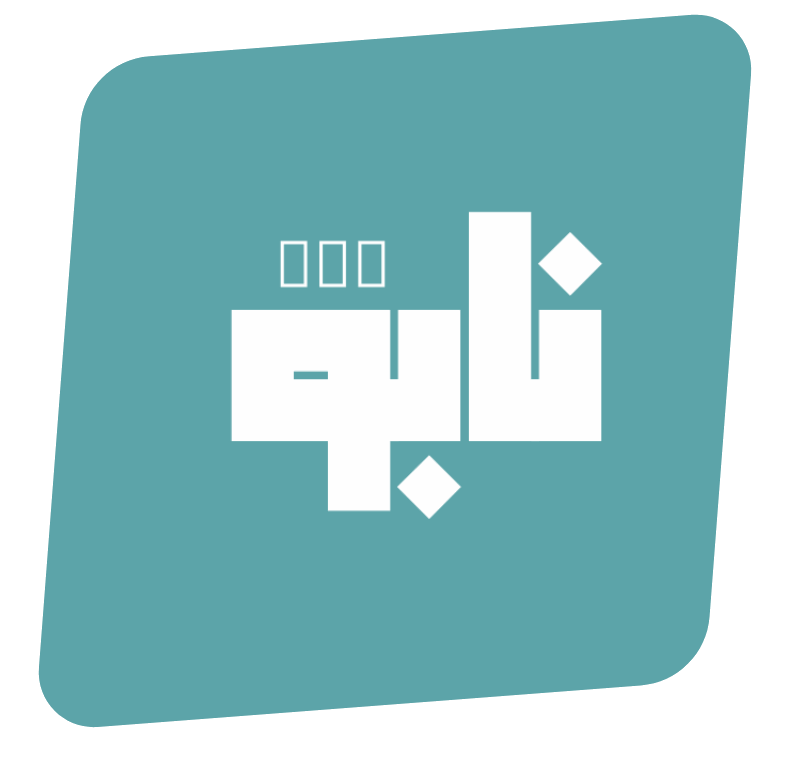حاوره – مناف عبد العزيز
رجل يسكنه السؤال، ويتغذّى على القلق المعرفي، ويكتب كما لو أنها الفرصة الأخيرة. لا يكتب ليملأ الصفحات، بل ليحفظ ما يتساقط من المعنى. كاتب يستطيع أن يُحوّل أبسط الانفعالات إلى نصّ، ويُسقِط أقسى الأفكار بلغة ناعمة. رجل مرضه المزمن هو الأسئلة، كما يصف نفسه، ويعيش عن طيب خاطر في منطقة اللايقين.
هو أول من قدّم نقدًا فلسفيًا عميقًا لنظرية العصبية عند ابن خلدون وطرح بديلاً عنها، وأول من فكّك مفهوم “إرادة القوة” لدى نيتشه وواجهها بنظرية إنسانية مضادة. وقد وصفه الشاعر أدونيس والدكتورة نايلة أبي نادر بأنه فيلسوف معاصر قدّم نظرية فلسفية عميقة تُعد من أهم ما كُتب في عصرنا. يوحي لك بأنه كاتب عادي، لكنه يمتلك عقلًا لا يهدأ. كاتب جعلني أنتظره ثلاثة أشهر لأجري معه هذا الحوار… ولم أندم. كاتب تُتداوَل مقالاته في مجتمعات لا يعرف من فيها من يقرؤه، ولا ينتظر مدحًا ولا ترويجًا.
ينحدر محمد الكلابي من عائلة ذات اسم وتاريخ عريق في العراق، وهي عائلة الجلبي الثقافية–السياسية المعروفة. وُلد في مدينة النجف، ودرس في الحوزة الدينية منذ صغره، وتم قبوله بعمر السادسة عشرة في معهد علم الاجتماع النفسي نظير تفوقه اللافت. بدأ مسيرته الصحفية مبكرًا، ونشر أولى مقالاته وهو في الخامسة عشرة من عمره.
ورغم صغر سنّه، فقد كوّن شبكة علاقات واسعة مع شخصيات سياسية ودينية وثقافية معروفة، لكنه لم يتكئ يومًا على اسم عائلته، بل شقّ طريقه وحده، بإرادة شخصية، وصوت فكري خاص.
له أبحاث ودراسات تُدرّس اليوم في جامعة بغداد وجامعة القاهرة، لما تتضمنه من أطروحات غير تقليدية. وقد فاز بجائزة أفضل كاتب عراقي لعام 2020، إلى جانب جوائز خليجية وعربية مرموقة. وهو أيضًا عضو في نقابة الصحفيين الأوروبيين.
عرفه الجمهور العراقي من خلال مواقفه الفكرية الجريئة، وبرز حضوره بقوة في ثورة تشرين من خلال كتاباته وتوجيهاته ومداخلاته التي لامست جوهر الأزمة، لا سطحها.
هذا الحوار ليس تعريفًا بكاتب، بل محاولة للاقتراب من منطقة الصمت فيه، حيث تُصاغ اللغة من شظايا الذات لا من زخرفة الأسلوب.
فإلى الحوار:
●. لماذا تكتب؟
أكتب لأنّ الصمت إن طال، سيتحوّل إلى استسلام.
والكتابة، عندي، ليست فعل تعبير… بل مقاومة هادئة لاندثارٍ صاخب.
●. ما هي أدواتك في الكتابة التي جعلت منك كاتباً متميّزاً ومبتكراً؟
بالتأكيد، لا كتابة بلا أدوات.
القراءة أولها، واللغة تاجها، والحسّ النقدي هو الميزان الذي لا يُعفي ولا يجامل. لكن، إن كان لي أن أختصر سرّي، فهو هذا:
في كل مرة أكتب فيها، أتصرف كما لو أنها آخر مرة سأكتب فيها. أقول بيني وبين نفسي: هذه فرصتك الأخيرة. لا تكتب لتُملأ صفحة، بل لتترك شيئاً يُقرأ وكأنّه اعتراف أخير.
ولهذا، أبذل في الكتابة ما لا أبذله في أي شيء آخر: نفسي.
●. هل ترى أن الجيل الحالي يحتاج إلى فلسفة جديدة؟ أم إلى شتيمة تُوقظه؟
الجيل الحالي لا يحتاج فلسفة جديدة ولا شتيمة… بل يحتاج إلى أن يفقد اليقين. لأن ما يقتل هذا الجيل ليس الجهل، بل الإجابات السريعة التي تمنحه شعوراً زائفاً بالفهم.
الفلسفة التي نحتاجها اليوم ليست نسقاً ولا نظرية، بل “لحظة توقّف”… لحظة انكسار أمام سؤال بسيط لا يجد له هذا الجيل تطبيقاً على الهاتف.
نحن لا نحتاج إلى فلاسفة يقولون لنا ما نفكر به، بل نحتاج إلى انهيار داخلي ناضج… إلى صدمة فكرية لا تشتمنا، بل تفضحنا.
الفلسفة الجديدة التي أنادي بها لا تبدأ من أرسطو، بل من هذا الإنسان المعزول خلف الشاشة، الذي لم يعد يعرف الفرق بين “أنا موجود” و”هاتفي مشحون”.
●. ألا ترى أن نقدك للحضارة الحديثة أحياناً يشبه بكاء رجل غني على الفقر؟
ربما… لكن هذا الغني لم يختر أن يولد ثرياً.
ولم يختر أن يرى الحقيقة من أعلى… لكنه، حين رآها، لم يحتفظ بها لنفسه. أنا لا أبكي على الفقر، بل أبكي من الثراء الذي انتزع المعنى من كل شيء ، من القدرة التي لم تُنتج حرية، بل مللًا، واستهلاكًا، وانفصالًا عن الذات.
الحضارة الحديثة ليست شريرة لأنها قوية… بل لأنها أفرغت الإنسان من نفسه وهو يضحك أمام الكاميرا. أنا لا أكتب من برج عاجي.
أنا أكتب من حافة انهيار داخلي ، ولعل من في الداخل لا يراه… لكن من في الخارج يُجبر على الصراخ.
●. ما الجريمة التي ارتكبها الإنسان المعاصر في حقّ ذاته دون أن يدرك؟
أكبر جريمة ارتكبها الإنسان المعاصر في حق نفسه هي قبوله بأن يتحوّل إلى وظيفة. أن يختزل ذاته في بطاقة، اسم مستخدم، إنجاز، انطباع، محتوى.
لقد خان الإنسان نفسه عندما سلّم إرادته للآلة، وإيمانه للمؤثر، وحقيقته للشكل ، عندما أصبح “يُعجب” أكثر مما “يفكر”، ويشارك أكثر مما يعيش. لم يُجبره أحد على ذلك… لقد فعلها بإرادته، ثم راح يشتكي من الاغتراب.
هذه الجريمة لا تُعاقب بسجن… بل بتكرار الحياة نفسها كل يوم دون أي شعور بالوجود.
●. في زمن وفرة الخيارات… لماذا يشعر الإنسان بالعجز أكثر من أي وقت؟
لأن كثرة الخيارات ليست حرية… بل شكل راقٍ من الإرباك والتخدير ،الإنسان الحديث لا يُخَيَّر، بل يُستدرَج.
تُعرض عليه الخيارات لتُرغمه على التفكير بطريقة واحدة: أيهما أفضل؟ لكن لا أحد يسأله: لماذا تريد هذا أصلاً؟ ومن الذي يختار من أجلك؟
وفرة الخيارات تصنع وهمًا اسمه “أنا أقرر”، بينما القرار محكوم مسبقًا بالعرض، بالصورة، بالخوارزمية، بالحشد. العجز لا يأتي من قلة الإمكانيات…
بل من تحوّل الإنسان إلى مستهلك دائم لاحتمالات لم يُنتجها.
هو يتنقّل بينها كعبدٍ حر، لا كحرٍّ واعٍ.
●. هل تخاف المستقبل؟ وما قراءتك له؟ كيف سيصبح الإنسان؟
أنا لا أخاف من المستقبل كزمن، بل أخاف من لحظة يتحوّل فيها الإنسان إلى زمن ميت. ما يُقلقني ليس ما سيأتي من الخارج، بل ما يُمحى من الداخل. أخشى من إنسان لا يُفكّر، ليس لأنه غبي، بل لأنه لا يرى حاجة للتفكير. إنسان لا يسأل، ليس لأنه وجد الإجابات، بل لأنه لم يعُد يشعر أنّ هناك ما يستحق السؤال. الإنسان القادم، كما أتصوّره، لن يكون وحشا ولا ملاكًا، بل كائناً وسطياً، مسالماً أكثر من اللازم، بلا موقف، بلا رغبة حقيقية، بلا خطأ يستحق الاعتراف. لن يُنكر مشاعره… بل سيُديرها. لن يكبت حزنه… بل يُعيد ضبطه عبر التطبيقات. سيضحك في التوقيت المناسب، ويبكي بلُغة محسوبة، ويتحدّث كما تُوصي واجهة الاستخدام. لا يعيش، بل يُمارس الحياة كما تُمارَس لعبة. لن يكون قاتلاً… بل “محايداً وجودياً”، لا يجرح أحداً، ولا ينقذ أحداً، حتى نفسه. المستقبل كما أراه ليس مأساة تُرتكب، بل تفاهة تُعمَّم. والإنسان لن ينهار فجأة، بل سيتلاشى تدريجيا دون أن يلاحظ أحد اختفاءه.
●. ما الشيء الذي تعتقد أنه قادم… ويخيفك؟ سياسياً أو ثقافياً أو تقنياً؟
ما يُخيفني ليس كارثة مفاجئة، بل تحوّل هادئ يجعل كل شيء يبدو “طبيعياً” بينما يُعاد تشكيلنا دون أن ننتبه. الخطر القادم لا يلبس وجه الطغيان، بل يأتي على هيئة “راحة”. لن يُطلب منك أن تطيع، بل ستُقنع نفسك أن ما يُعرض عليك هو بالضبط ما أردت. سياسياً، أخشى من ظهور نمط جديد من السلطة لا يمنعك… بل يُعيد تصميم سلوكك بحيث لا تعود بحاجة للمنع. لن يقول لك النظام “افعل”، بل سيجعلك تصل من تلقاء نفسك إلى الخيار الذي أراده لك، وتُقسم أنك اخترته بحرية. تخيّل أن تستيقظ كل صباح، وتجد هاتفك يقترح عليك ماذا تفكّر، من تقرأ، ماذا تشتري، متى ترتاح… ليس بفرضٍ مباشر، بل عبر ملايين الإشارات التي جُمعت عنك بصمت. لا أحد يأمرك، لكنك تطاوع ما يبدو وكأنه “ذكاؤك الشخصي”. هذا هو الوجه الجديد للسيطرة: أن تتحوّل الحريّة إلى وهم ذكي.
ثقافياً، ما يُقلقني هو اليوم الذي تُستبدل فيه الأسئلة العميقة بمحتوى تفاعلي، والاختلاف الحقيقي بلعبة الآراء، ويصبح الهدف ليس أن تعرف، بل أن “تبدو مثيرا للاهتمام”. لن تختار ما تقرأ لأنه أثّر بك، بل لأنه سيُعجب من يتابعك. لن تقول رأيك لأنه نابع من قناعة، بل لأنه سيُسجَّل كموقف أنيق على الشاشة. سنغرق في محيط من الخيارات… لكن بلا بوصلة.
تقنياً، المثال الأوضح أمامنا هو تجربة “نتفلكس”:
ملايين المشاهدين يعتقدون أنهم يختارون ما يشاهدونه، بينما في الحقيقة يتم توجيههم وفق خوارزميات تعلّمت كل شيء عن ذوقهم، مزاجهم، توقيتهم، وحتى مدى استعدادهم للبكاء أو الضحك. هذا هو النموذج الذي يُصدّر الآن إلى السياسة، إلى الاقتصاد، إلى التعليم… بل إلى شكل العلاقات الشخصية نفسها.
الخطر الحقيقي ليس في أن نُراقَب، بل في أن نتكيّف مع المراقبة حتى نشتاق لها إن غابت. أن لا نعود نطلب من العالم أن يكون حقيقيا… بل أن يكون مُريحا.
وهذه هي السلطة الجديدة: لا تجبرك، لا تخيفك، لا تهددك. فقط… تُريحك حتى تنسى أنك كنت حيًا.
●. هل عشت الحب كما تكتبه؟ أم أنك فقط تعرفه نظريًا؟
- أحياناً لا تعرف أنك تحب، لكنك تلاحظ أنك أصبحت أكثر إنصاتاً، أكثر صمتاً، أكثر حرصاً على التفاصيل الصغيرة التي لم تكن تعني لك شيئاً من قبل. لا شيء فيك يتغيّر بشكل صاخب، لكن كل شيء يتحرّك ببطء نحو شخصٍ ما، كما لو أن داخلك يُعاد ترتيبه ليتّسع له. لا أكتب عن الحب لأنني أمتلك تعريفاً له، بل لأنني أشعر أنه هو من يمتلكني حين أكتب. ليس شعوراً يمكن شرحه، بل لغة جديدة ترى بها العالم. حين أكتب عن الحب، لا أُحلّله، بل أحاول أن أُبقي أثره فيّ حياً. أن لا أنساه إن غاب، وأن لا أضيّعه إن حضر. كل ما أعرفه الآن أنني لا أختار الكلمات، بل الكلمات تختارني حين يمر طيفه في رأسي. وهذا كافٍ لأفهم أنني لم أعد كما كنت… وهذا، بحدّ ذاته، حب.

●. يقال إن الكاتب لا ينجو من نفسه… هل تحاول النجاة أم الغرق بوعي؟
أنا لا أحاول النجاة… ولا أُغرق نفسي عمداً ،،، ما أفعله هو أشبه بمحاولة الغوص في ذاتي دون خريطة، مع علمي المُسبق أن القاع قد لا يُطاق.
النجاة بالنسبة لي ليست هدفاً، بل أثرا جانبياً للصدق. حين أكتب، لا أبحث عن الراحة… بل عن الكشف. وأعرف أنني كلّما كشفت شيئاً، خُدشت أكثر.
وقد قال سيوران مرة: «الكاتب الحقيقي هو من ينقّب في نفسه كما ينقّب في جثة».
وإن كان هذا صحيحاً، فأنا أكتب لا لأبني صورة عني، بل لأفتّش فيّ عما لا يُقال ولا يُحتمل.
فإن نجوت، فبفعل الكتابة… وإن غَرِقت، فبسببها أيضاً.
●. ما الشيء الذي تُجيده خارج الكتابة؟ موهبة لا يعرفها الناس؟
ليست موهبة، بل متعة خفية: أُتقن تركيب العطور كما لو أنني أكتب روائح. كل مزيج هو جملة غير منطوقة، وكل رائحة قصة تُروى دون كلمات. العطر بالنسبة لي طريقة للوجود… دون ضجيج.
●. هل ترى أن أكثر من يمتلكون القوة اليوم… لا يعرفون ماذا يفعلون بها؟
نعم، كثير ممن يمتلكون القوة اليوم لا يعرفون ماذا يفعلون بها، ليس لأنهم أشرار، بل لأنهم لم يهيئوا أنفسهم ليكونوا مسؤولين عن شيء. القوة الحقيقية ليست أن تفرض، بل أن تفهم أولاً وزن ما تحمله. أغلب الناس حين يصلون إلى موقع فيه تأثير، يظنّون أن اللحظة قد جاءت ليُثبتوا أنفسهم، فينسون أن القوة لا تُثبت أحدًا… بل تفضحه.
تخيّل شاباً فجأة يمتلك المال، أو أباً يكتسب سلطة على أطفاله، أو مديراً يُعطى القرار في مصير فريق. في اللحظة الأولى، ينسى أغلبهم أن ما أُعطي لهم ليس “امتيازاً”، بل “امتحان”.
أعرف شخصاً كان موظفاً بسيطاً، يتحمّل الضغط بصبر، ويعامل الجميع بلطف. وبعد ترقيته صار قاسياً، متوتّراً، يعتقد أن عليه أن يفرض نفسه بصوتٍ أعلى. لكنه لم يفهم أن القوة لا تعني أن تُسمِع الجميع صوتك، بل أن تجعل من حولك يشعرون بالأمان وأنت في الأعلى.
القوة بدون وعي تتحوّل إلى مرآة مشوّهة: يرى الإنسان فيها ما يريد إثباته، لا ما يحتاج إصلاحه.
ولهذا أقول دائماً: لا تعطِ أحداً القوة لترى حقيقته… بل راقب ما يفعله حين يخاف أن يخسرها. عندها فقط، ستعرف إن كان أهلًا لها أم مجرد سجين فيها.
●. ما رأيك بالشهرة؟ هل تريدها، أم تخشاها؟
الشهرة؟ لا أريدها ولا أخشاها، لكنني أخاف من أثرها على المعنى. أنا لا أكتب لأُعرف، بل لأبقى على قيد الصدق. إذا أتت الشهرة يومًا، فلتأتِ لأن ما أقوله مسّ أحدهم في نقطة لم يعرف كيف يعبّر عنها. أما أن تُصبح هي الغاية، فذلك موت ناعم لا رائحة له.
●هل ترى أن الالتزام اليوم قيمة حقيقية أم عبء ثقيل؟ وهل يمكن للإنسان أن يكون حرًّا وهو ملتزم في الوقت نفسه؟
الالتزام ليس قيمة مطلقة ولا عبئًا مطلقًا… بل مرآة تكشف من أنت. كمثال على ذلك، قبل أيام قررت أن ألتزم بنظام غذائي صارم. اكتشفت سريعًا أن الالتزام لا يختبر معدتك، بل علاقتك بنفسك: هل أنت سيدها أم عبد رغباتها؟ الحرية لا تعني أن تفعل ما تشاء، ولا الالتزام يعني أن تُقيد نفسك. الحرية الحقيقية أن تعرف لماذا تفعل ما تفعل. إن لم يُخرجك الالتزام أكثر صدقًا مع نفسك، فأنت لم تتحرر… بل بدّلت قيودك.
●. ماذا تريد أن يُقال عنك بعد موتك؟
على المستوى الشخصي، لا يهمّني أن يُقال عني شيء، وربما لن يتذكّرني أحد. أنا لا أراهن على الذاكرة، بل على الأثر. ما أريده حقاً هو أن يفتح أحدهم كتاباً كتبته، بعد موتي بسنوات، ويجد فيه فكرة تُوقظه، أو جملة تُشبهه أكثر مما كان يظنّ. لا أريد أن يُقال: “كان عظيماً”… بل أن يتوقّف أحدهم عند سطر ويهمس: “هذا السطر أنقذني.”
●. هل هناك نسخة من “محمد الكلابي” تتمنّى أن تلتقي بها؟ ولماذا لم تصبحها؟
النسخة التي أودّ لقاءها منّي… لا وجود لها. ليست شخصاً آخر كنتُ أتمنّى أن أكونه، بل سؤالًا حيّاً ما زال يبحث عن شكله. أنا لا أؤمن بفكرة “النسخة الأفضل” كما تُروَّج: نسخة أكثر نجاحاً، أكثر تهذيباً، أكثر إنتاجاً. هذه ليست نسخة، بل إعلان تسويقي للذات. النسخة الوحيدة التي راودتني فعلًا… هي تلك التي كانت ستجرؤ أن تفشل تماما، ثم تعود لتكتب عن فشلها بصدق دون أن تنكسر. لماذا لم أُصبحها؟ ربما لأنني كنت أذكى من أن أنجو… وأجبن من أن أتهشّم. بقيت في المنتصف، أحاول أن أكتبني كما أنا، لا كما يُفترض أن أكون.
●. هل ما زلت تؤمن أن الكتابة يمكن أن تُغيّر شيئا… أم أنك تكتب فقط كي لا تختنق؟
الكتابة ما زالت عندي قادرة على التغيير، لكنها لا تغيّر العالم كما يعتقد البعض… بل تغيّر طريقة الشخص في الوقوف داخله. الكتابة لا تمنع السقوط، لكنها تُعطيك وعيًا به، وتمنحك لغة تسقط بها بكرامة. نعم، أكتب كي لا أختنق، لكنني أختنق تحديدًا لأن العالم لا يُكتب كما هو… ولهذا أكتب. ما زلت أؤمن أن سطراً صادقاً، يُقال في اللحظة المناسبة، يمكن أن ينقذ شخصا كان يعتقد أن لا أحد يفهمه. وهذا، في زمن السرعة… معجزة صغيرة تكفي.
●. وأخيراً… ما السؤال الذي تخشاه أن يُطرَح عليك؟ ولو طُرح… لانتهى كل شيء؟
السؤال الذي أخشاه؟ هو سؤال لا يُوجَّه بصوت، بل يُقال بين السطور: “أين كنت عندما احتاجك من أحبك؟”
لأنني أعرف الإجابة… وأعرف أنها ستُحطّم شيئاً لا يُصلَح في داخلي.