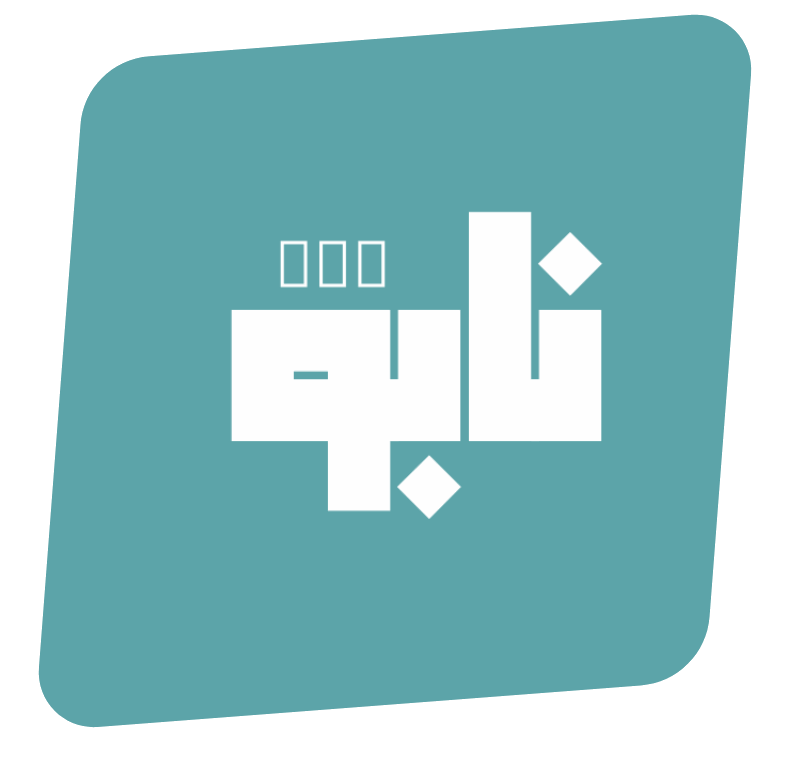د. عصام البرّام
القاهرة
تُعد الهوية الثقافية أحد أهم الركائز التي تقوم عليها المجتمعات، فهي الوعاء الذي يحمل الذاكرة الجماعية، ويصون القيم، ويجسد التاريخ المشترك للشعوب. غير أن هذه الهوية تجد نفسها اليوم في مواجهة تهديدات غير مسبوقة بفعل الصراعات الإقليمية التي تعصف بعدد كبير من دول العالم، ولا سيما في المنطقة العربية. فالحروب لم تعد تقتصر على تدمير البنية التحتية أو إنهاك الاقتصادات، بل امتدت لتطال جوهر الوجود الثقافي، مستهدفة التراث المادي واللامادي، ومهددة بانقطاع الصلة بين الماضي والحاضر، وبين الأجيال المتعاقبة.
في ظل الصراعات، يتحول التراث الثقافي إلى ضحية صامتة. فالمتاحف تُنهب، والمواقع الأثرية تُدمَّر، والمخطوطات تُحرق أو تُهرَّب، والمعالم التاريخية تُستهدف أحيانًا عن قصد بوصفها رموزًا لهوية جماعية يراد محوها. هذا الاستهداف لا يحدث عرضًا، بل يعكس إدراكًا عميقًا لدى أطراف النزاع بأن تدمير الثقافة هو وسيلة فعالة لكسر إرادة الشعوب وإضعاف تماسكها. فحين يُمحى التاريخ وتُشوَّه الذاكرة، يصبح من السهل إعادة تشكيل الوعي الجمعي وفق روايات جديدة تخدم مصالح القوى المتصارعة.
ولا يقتصر الخطر على التراث المادي فحسب، بل يمتد إلى التراث اللامادي الذي يشمل اللغة، والعادات، والتقاليد، والفنون الشعبية، وأنماط العيش. ففي أجواء النزوح واللجوء، يجد الأفراد أنفسهم مجبرين على التكيف مع بيئات جديدة، ما يؤدي تدريجيًا إلى تآكل ملامح ثقافتهم الأصلية، خصوصًا لدى الأجيال الشابة التي تنشأ بعيدًا عن موطنها. ومع مرور الوقت، قد تتحول الهوية الثقافية إلى مجرد ذكرى، أو إلى مزيج مشوش من الانتماءات، يفتقر إلى الجذور الراسخة.
إن الصراعات الإقليمية لا تؤثر فقط في الدول المنخرطة مباشرة في الحروب، بل تمتد آثارها إلى دول الجوار، حيث تفرض تحديات ثقافية جديدة تتعلق بالاندماج، والتعايش، والحفاظ على الخصوصيات الثقافية. وفي كثير من الأحيان، تُختزل الثقافة في أطر ضيقة، أو تُستخدم كأداة سياسية لتعميق الانقسامات، بدل أن تكون جسرًا للتفاهم والحوار. وهنا تبرز إشكالية خطيرة تتمثل في تسييس الهوية الثقافية، وتحويلها من عامل وحدة إلى سبب للصراع.
أمام هذا الواقع القاتم، يبرز سؤال ملح: من ينقذ التراث؟ هل تقع المسؤولية على عاتق الحكومات وحدها، أم أن المجتمع الدولي مطالب بدور أكثر فاعلية، أم أن المجتمعات المحلية هي خط الدفاع الأول والأخير؟ الحقيقة أن إنقاذ التراث مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود على مختلف المستويات. فالحكومات، رغم انشغالها بإدارة الأزمات الأمنية والسياسية، مطالبة بوضع حماية التراث ضمن أولوياتها، وسن التشريعات اللازمة، وتوفير الدعم للمؤسسات الثقافية، حتى في أحلك الظروف.
أما المجتمع الدولي، فيتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه حماية التراث الإنساني المشترك. فالتراث لا يخص شعبًا بعينه، بل يمثل جزءًا من ذاكرة الإنسانية جمعاء. وقد شهدنا مبادرات دولية تهدف إلى حماية المواقع الأثرية، ومكافحة تهريب الآثار، وتوثيق التراث المهدد بالاندثار، إلا أن هذه الجهود ما زالت دون المستوى المطلوب، وغالبًا ما تصطدم بحسابات سياسية أو بنقص في التمويل والإرادة.
وفي المقابل، تلعب المجتمعات المحلية دورًا محوريًا في الحفاظ على التراث، إذ إن الوعي المجتمعي بقيمة الثقافة يمكن أن يشكل خط الدفاع الأول ضد محاولات الطمس والتشويه. فحين يدرك الأفراد أن تراثهم هو جزء من هويتهم وكرامتهم، يصبحون أكثر استعدادًا للدفاع عنه، ونقله إلى أبنائهم، حتى في ظروف القهر والتشرد. كما أن المبادرات الأهلية، والمشاريع الثقافية الصغيرة، والتوثيق الشعبي، تمثل أدوات فعالة في حفظ الذاكرة الجماعية من الضياع.
ولا يمكن إغفال دور المثقفين والفنانين والكتاب في هذه المعركة. فالإبداع الثقافي في زمن الصراع يتحول إلى فعل مقاومة، وإلى وسيلة لتأكيد الوجود، وإعادة سرد الحكاية من منظور أصحابها الحقيقيين. فالأدب، والفن، والموسيقى، والسينما، ليست مجرد أشكال تعبير جمالي، بل هي أدوات لحفظ الهوية، وبناء الوعي، ومواجهة محاولات الاختزال والتزييف.
إن التكنولوجيا الحديثة تفتح آفاقًا جديدة أمام حماية التراث، من خلال الرقمنة، والتوثيق الافتراضي، ونشر المحتوى الثقافي عبر المنصات الرقمية. ورغم المخاطر المرتبطة باستخدام هذه الوسائل، فإنها تظل فرصة ثمينة لضمان وصول التراث إلى أوسع شريحة ممكنة، ولحمايته من الفقدان الكامل في حال تدمير الأصول المادية. غير أن الاعتماد على التكنولوجيا يجب أن يكون جزءًا من رؤية شاملة، لا بديلاً عن الجهود الميدانية والمؤسسية.
من هنا، تظل الهوية الثقافية في قلب الصراع، لأنها تمثل جوهر ما نحن عليه، وما نطمح أن نكونه. وإن إنقاذ التراث ليس ترفًا ثقافيًا، بل هو شرط أساسي لبناء مستقبل متوازن، قائم على المصالحة مع الذات، واحترام التنوع، والاعتراف بقيمة التاريخ. ففي عالم تمزقه الصراعات، يبقى الحفاظ على الثقافة فعل أمل، ورسالة مقاومة، وجسرًا يعيد وصل ما انقطع بين الماضي والحاضر، ويمنح الأجيال القادمة حقها في ذاكرة حية وهوية نابضة.
في سياق الحديث عن الهوية الثقافية في ظل الصراعات الإقليمية، لا بد من التوقف عند الأثر النفسي العميق الذي يخلّفه تدمير التراث على الأفراد والجماعات. ففقدان المعالم التاريخية، واندثار الرموز الثقافية، لا يعني فقط خسارة حجارة أو مخطوطات، بل يمثل انكسارًا في الشعور بالانتماء والاستمرارية. الإنسان يحتاج إلى جذور يتكئ عليها في مواجهة الأزمات، وعندما تُقتلع هذه الجذور، يصبح أكثر عرضة للاغتراب والضياع، ما ينعكس سلبًا على قدرته على الصمود وإعادة البناء بعد انتهاء الصراعات.
كما أن تدمير التراث يسهم في إطالة أمد النزاعات بدل إنهائها، إذ يغذي مشاعر الحقد والرغبة في الانتقام، ويعمّق الهوة بين المكونات الاجتماعية المختلفة. فحين تُستهدف ثقافة جماعة معينة، يُنظر إلى ذلك على أنه استهداف لوجودها ذاته، ما يعزز منطق الإقصاء ويقوّض فرص المصالحة الوطنية. ومن هنا، فإن حماية التراث يجب أن تُدرج ضمن مسارات بناء السلام، لا باعتبارها قضية ثانوية، بل كعنصر أساسي في إعادة ترميم الثقة بين المجتمعات المتنازعة.
وفي هذا الإطار، يبرز دور التعليم بوصفه أداة استراتيجية للحفاظ على الهوية الثقافية. فالمناهج الدراسية التي تُعنى بالتاريخ والتراث، وتقدّم سرديات جامعة غير إقصائية، تسهم في تنشئة أجيال واعية بقيمة التنوع الثقافي، وقادرة على مقاومة خطابات الكراهية والتطرف. التعليم هنا لا يقتصر على المدارس، بل يشمل الفضاءات الثقافية والإعلامية التي تشكل وعي الرأي العام وتؤثر في نظرته إلى ذاته وإلى الآخر.
إن مستقبل الهوية الثقافية في مناطق الصراع مرهون بمدى قدرتنا على التعامل مع الثقافة بوصفها حقًا إنسانيًا أصيلًا، لا يقل أهمية عن الحق في الحياة والأمن. فحين تُحمى الثقافة، يُحمى الإنسان في جوهره، وتُصان ذاكرته، وتُفتح أمامه آفاق الأمل في غدٍ أكثر استقرارًا وعدالة. ومن هذا المنطلق، يصبح إنقاذ التراث ليس مجرد مسؤولية أخلاقية، بل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الشعوب، وضمانة أساسية لبقاء هويتها حيّة رغم كل محاولات الطمس والتدمير.