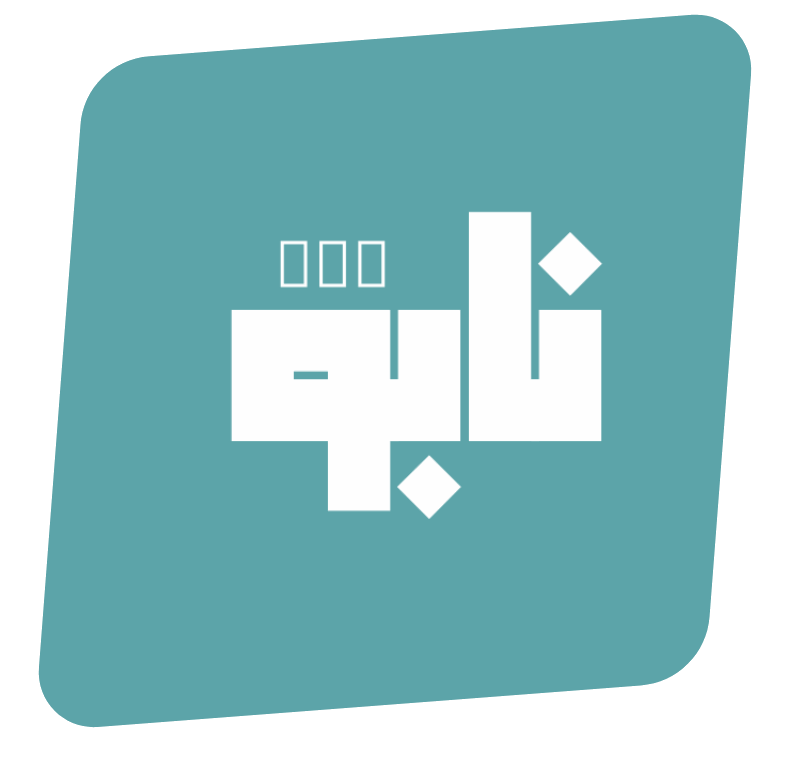منذ اللحظة التي يظهر فيها المذيع على الشاشة، لا يعود إنساناً عادياً. فالصوت لم يعد مجرد نبرة شخصية، والملامح لم تعد مجرد ملامح؛ بل كل تفصيلة تتحوّل إلى “علامة” تُقرأ وتُفسَّر وتُحمَّل بمعانٍ أكبر مما تحتمل. هنا يولد السؤال: هل يصنع المذيع هويته الإعلامية بنفسه، أم تصنعه الشاشة كما يُصاغ القناع على وجه الممثل؟
الهوية الإعلامية ليست ديكوراً ولا هي نتاج صدفة. إنها بناء معقد يتداخل فيه الخاص والعام، الذاتي والموضوعي، الصادق والمصطنع. المذيع يبدأ من صوته، حضوره، ثقافته، لكن هذه العناصر لا تكفي وحدها. فالهالة التي يكتسبها أمام الجمهور تولد من صراع خفي: صراع بين “الأنا الحقيقية” التي تريد أن تظهر، و”الأنا التلفزيونية” التي تُفرَض عليه بفعل تقاليد الشاشة وقوانينها الخفية.
الفيلسوف الكندي مارشال ماكلوهان، الذي قال عبارته الشهيرة “الوسيلة هي الرسالة”, يوضح أن الوسيط نفسه (الشاشة هنا) يعيد تشكيل المضمون والذات معاً. وهذا ينطبق على المذيع: فحتى لو امتلك شخصية قوية، فإن مجرد ظهوره عبر التلفزيون يفرض عليه شكلاً جديداً من الهوية يتجاوز رغبته الفردية.
ولعل أخطر ما يواجه المذيع هو لحظة “فقدان الحدود”: حين لا يعود يعرف أين تنتهي شخصيته الحقيقية وأين تبدأ شخصيته الإعلامية. المذيعة الأميركية أوبرا وينفري مثلاً صنعت هوية إعلامية تجاوزت الشاشة لتصبح جزءاً من الثقافة الأميركية نفسها. لكنها في أكثر من مقابلة اعترفت أنها عاشت صراعاً مع صورتها العلنية، حيث صار الجمهور يعرفها أكثر مما تعرف نفسها.
في العالم العربي، يمكن أن نذكر تجربة غسان بن جدو بعد استقالته الشهيرة من “الجزيرة” عام 2011. هنا لم تكن الهوية الإعلامية مجرد أداء أمام الكاميرا، بل تحولت إلى موقف سياسي وجودي، حيث تماهت شخصيته الإعلامية مع موقفه الشخصي إلى حد لم يعد ممكناً الفصل بينهما. المثال يوضح أن المذيع الذي يملك موقفاً فكرياً أو سياسياً يوسّع هويته لتتجاوز القالب.
وعلى الجانب الآخر، ثمة مذيعون ذابوا تماماً في القالب حتى صاروا نسخاً مكررة. كثير من الوجوه التي تتناوب على نشرات الأخبار في القنوات العربية مثلاً، تكاد تكون بلا بصمة شخصية: نبرة واحدة، حركات مدروسة، مظهر متشابه. هنا يتحقق ما وصفه المفكر الفرنسي غي دوبور بـ”مجتمع المشهد”، حيث يغدو المذيع مجرد واجهة باردة، أداة لنقل الصورة لا أكثر.
لكن الهوية الإعلامية ليست دائماً قيداً، بل قد تكون فرصة للتحرر. المذيع الذي يملك ثقافة عميقة وقدرة على التفكير، يستطيع أن يستغل الشاشة لا لتُشكِّله، بل ليعيد تشكيلها. هنا يصبح القناع وسيلة تعبير، لا أداة إخفاء. الفرق بين مذيع يقرأ ما يُكتب له على “الأوتوكيو” بلا روح، ومذيع يترك أثراً حتى في أبسط جملة، يكمن في هذه القدرة على تحويل الصوت والصورة إلى معنى يتجاوز النص المكتوب.
في العراق، تجربة حافظ القباني في الإعلام الرياضي مثال على المذيع الذي يصنع أسلوبه الخاص: سرعة الأداء، الروح الشعبية، والقدرة على دمج التحليل بالسرد. هوية تنبع من الداخل أكثر مما تُفرض من الخارج. وفي المقابل، ثمة مذيعون لم يعرف عنهم الجمهور سوى وجوههم على الشاشة، بلا أثر ثقافي أو فكري بعد الغياب.
يبقى السؤال الأعمق: هل المذيع يملك هويته فعلاً أم أنها تُمنح له؟ الواقع أن الهوية الإعلامية تُبنى في منطقة وسطى: بين صدق الداخل وضغط الخارج، بين ما يريده هو وما يفرضه الجمهور والسوق والشاشة. ومن ينجح هو من يحوّل هذا التوتر نفسه إلى مادة إبداع، فيبدو صادقاً حتى وهو يرتدي قناعاً.