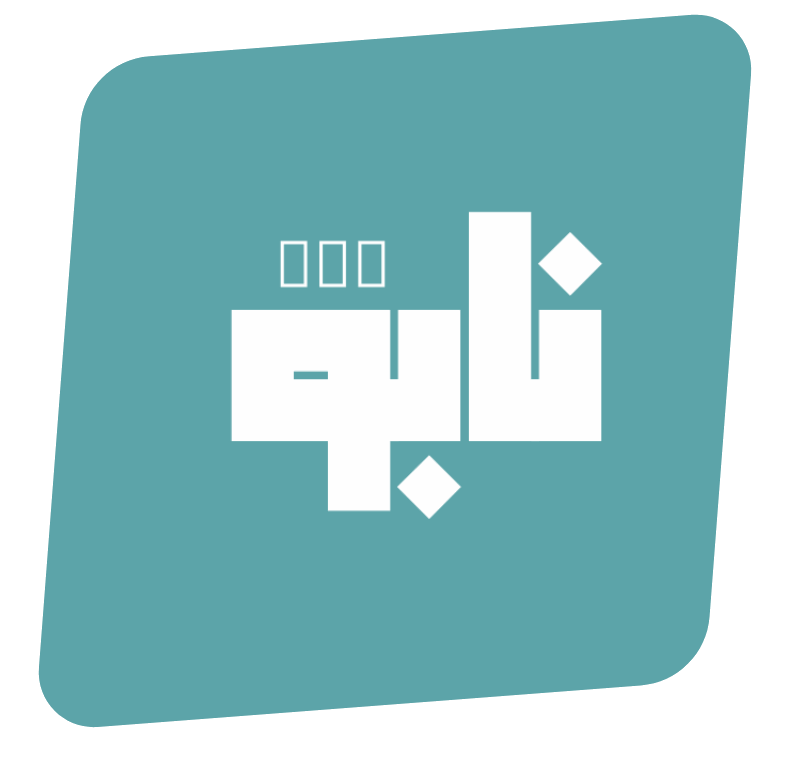محمد الكلابي
منذ أن وُجد الإنسان وهو يبحث عن ما يتجاوز تفاصيل يومه القصيرة. شيء يفسّر معنى وجوده، ويمنحه طمأنينة وسط الخوف من المصير. الدين لم يكن يوماً طقساً عابراً أو شعاراً اجتماعياً، بل كان دائماً البوصلة التي تهدي وتُعيد ترتيب الداخل. ومع ذلك، نرى اليوم من ينفر منه وكأنه صار عبئاً أو عائقاً، مع أن النفور في حقيقته لا يكشف خللاً في الدين بقدر ما يكشف أزمة في فهمنا نحن.
أول ما يغذّي هذا النفور هو الخلط بين الأصل وتمثيلاته. حين يخطئ المتدين أو يسيء، يظن الناس أن الدين هو الذي أساء. هذا مثل من يرفض الطب لأن طبيباً خانه. الزجاج قد يتشقق، لكن الضوء يظل نوراً. وحين يصبح الدين مرهوناً بسلوك البشر، يغدو هشّاً ينهار مع أول سقوط اجتماعي. لذلك يذكّرنا الوحي أن الحق لا يُقاس بالكثرة ولا بالمزاج العام: «وإن تُطع أكثرَ من في الأرض يُضلّوك عن سبيل الله» (الأنعام: 116).
لكن النفور لا يتوقف هنا؛ فالجهل يضاعفه. بعض الناس أهملوا الدين تماماً، اكتفوا بعبارة فضفاضة: “أنا مؤمن”، دون معرفة ولا تدبّر. وبعضهم دخل إليه بسطحية فخرج منه بالتشدد، يقرأ بلا سياق ولا تاريخ، فيحوّل النص إلى أداة قسوة لا إلى منبع هداية. كلاهما وقع في فخ السطحية: الأول سطحية التجاهل، والثاني سطحية الغلو. بينما التعمق الواعي في النص والتاريخ يكشف أن الدين في جوهره نور واستقرار، لا تعقيد ولا انغلاق. وقد لخّص الإمام علي (ع) هذه الحقيقة بقوله: «الناس أعداء ما جهلوا»؛ فالجهل بالدين جعل بعضهم ينفر منه وجعل آخرين يسيئون باسمه.
وإلى جانب ذلك ينتشر وهمٌ مريح لكنه خطير: “يكفيني أن أعرف الله وأكون طيباً”. هذه العبارة تبدو متواضعة لكنها في جوهرها استقالة من المسؤولية. الطيبة بلا معرفة سراب، لأنها تبرّر الكسل وتترك الفراغ مفتوحاً أمام الانحراف. مثل من يقول “أحب وطني” لكنه يرفض أن يعرف تاريخه وقوانينه، فلا يخدم وطنه بل يخذله. وكذلك الدين: لا يُصان بالنيات وحدها، بل بالفهم الذي يحوّل النية إلى وعي وعمل.
هذه الأزمة الفكرية تتعزز نفسياً واجتماعياً. فمع تكرار النماذج السيئة يتولد شعور بالعجز واليأس، وتعمل وسائل التواصل على تضخيم الصورة السلبية حتى يترسّخ الاعتقاد أن الدين لا يُنتج سوى تشوه. وهكذا يتحوّل الاشمئزاز من فعلٍ فردي إلى قطيعة مع الأصل كله، فيفقد الإنسان بوصلته ويغرق في الفراغ.
لكن الفراغ لا يملؤه بديل. من يبتعد عن الإيمان يكتشف سريعاً أنه لم يتحرر بل صار أسير العبث، يطارد نزعات مادية أو موضات فكرية لا تمنحه راحة ولا معنى. والتاريخ شاهد: كل حضارة هجرت إيمانها انتهت إلى العدم، لأن الدين ليس قيداً يعيق الحياة، بل هو ما يمنحها المعنى ويثبّت خطواتها. وقد لخّص القرآن هذا المعنى حين قال: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب» (الرعد: 28). فالاطمئنان الذي يبحث عنه الناس في كل مكان، هو في جوهره ثمرة الإيمان لا بديله.
الحل ليس في الهروب من الدين بل في العودة الواعية إليه. أن نقرأ النصوص بروح الباحث عن الهداية لا بروح الخائف من التعقيد. أن نفهم التاريخ لنفرّق بين جوهر الدين وانحرافات البشر. أن نتحمّل مسؤوليتنا الفردية في بناء إيمان متين يقوم على المعرفة والوعي لا على الصور الاجتماعية. الدين ليس ملكاً لجماعة، بل عهد شخصي بين الإنسان وربه.
الدين لا يسقط لأن بعض الأيدي لوّثت صورته، ولا ينهار لأن المرايا انكسرت. الذي ينهار هو الإيمان السطحي الذي ارتبط بالانعكاس ونسي الأصل. الزبد قد يعلو لحظة لكنه يزول، أما ما ينفع الناس فيبقى. الامتحان ليس أن نجد وجوهاً بلا خطأ، بل أن نحافظ على نورنا رغم الشقوق من حولنا. فإذا أساء الناس باسم الدين، فالمطلوب أن ننقذ الدين منهم لا أن نتركه معهم. لأن فقدان الإيمان ليس حرية، بل سقوط في فراغٍ لا قرار له. والإيمان الحقّ هو الذي يبني يقيناً على أصل ثابت، يمنح القلب طمأنينة ويمنح الإنسان معنى. عندها فقط تستقيم البوصلة، ويعود كل شيء إلى مكانه: الأصل أصل، المرآة مرآة، والنور نور.