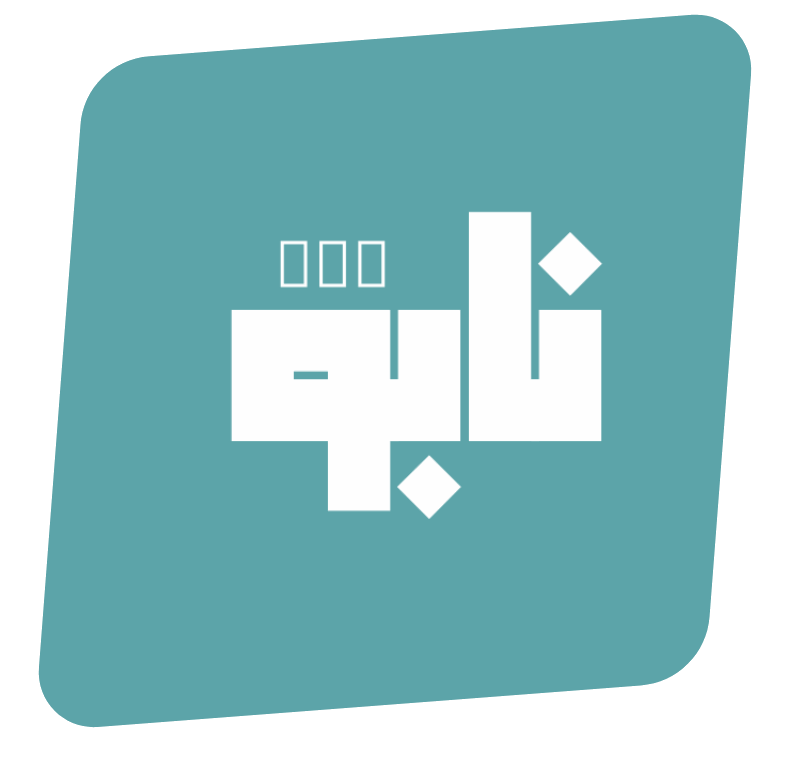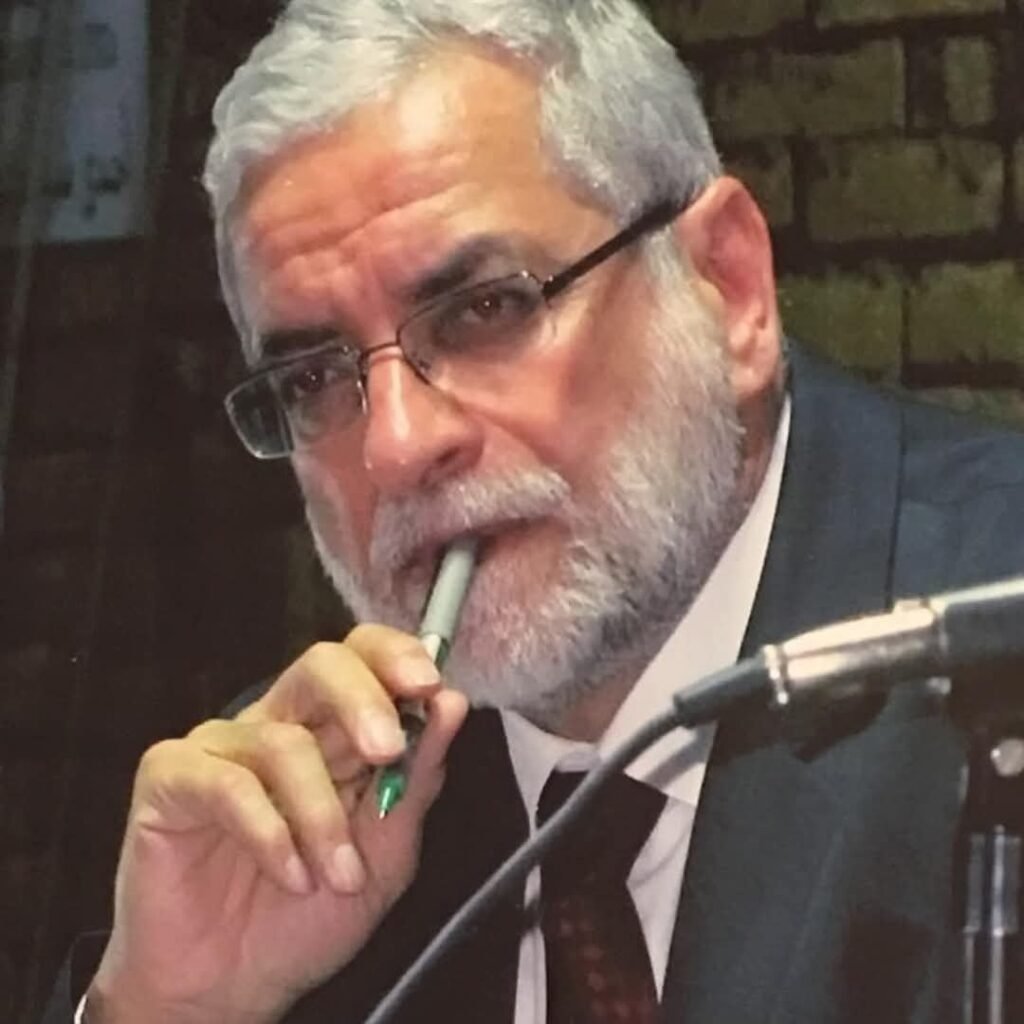محمد عبد الجبار الشبوط
حين تُفهم المهدوية بوصفها قوة دافعة للحراك الحضاري في مسيرة ارتقاء الإنسان وتكامل الشعوبوالبشرية فإنها تخرج من الإطار الضيق الذي حُصرت فيه طويلًا بوصفها انتظارًا لحدث غيبي منفصل عنحركة التاريخ، وتدخل مجال الفلسفة التاريخية التي ترى في العقيدة طاقةً فاعلة في الزمن لا خبرًا عنزمن آخر، إذ لا تعود المهدوية في هذا الأفق نقطةً مستقبلية معلّقة على تقويم الغيب، بل تتحول إلىمحرك داخلي يشدّ المسار الإنساني نحو الأعلى كلما تعرّض للانكسار أو الانحراف، وبذلك تصبح شبيهةبالقانون الأخلاقي الكامن في ضمير البشرية الذي يدفعها، رغم الحروب والظلم والتراجع، إلى البحثالدائم عن نظام أعدل وحياة أكرم وصيغة تعايش أرقى، وهو ما يعني أن المهدوية لا تقف في نهايةالطريق بل تعمل داخل الطريق نفسه بوصفها الجاذبية المعنوية التي تمنع التاريخ من الاستسلام النهائيللظلم.
هذا الفهم يبدّل مركز الثقل من الشخص إلى المسار، ومن الحدث إلى القانون، ومن الترقّب إلى الفعل،لأن التركيز على المهدوية كقوة دافعة يعني أن السؤال لم يعد متى يظهر الفرد، بل كيف يرتقي الإنسان،ولم يعد البحث في تفاصيل الغيب، بل في شروط النضج الأخلاقي والمؤسسي الذي يسمح بقيام العدلعلى نطاق واسع، فالمهدوية هنا ليست وعدًا بإلغاء سنن الاجتماع البشري ولا قفزةً سحرية تتجاوزقوانين الوعي والتاريخ، بل أفق أعلى لهذه السنن نفسها، حيث يتكامل تطور الإنسان الداخلي مع تطورمؤسساته وقوانينه، ويصبح العدل نتيجة نضج طويل لا مجرد فرض خارجي، وبهذا المعنى تكونالمهدوية تعبيرًا عن إيمان عميق بقابلية الإنسان للتحسن المستمر، وبأن التاريخ الإنساني ليس دائرةمغلقة من الاستبداد المتكرر، بل مسار مفتوح قابل للارتقاء.
وعندما تُوصَف المهدوية بأنها قوة دافعة لارتقاء الإنسان فإنها تُفهَم كطاقة أخلاقية تضغط على وعيالبشر من الداخل، فتجعلهم غير راضين عن الظلم حتى حين يعتادونه، وغير مكتفين بأنظمة ناقصة حتىحين يستقرون فيها، لأن حضور هذا الأفق في الضمير الجمعي يولّد توترًا إيجابيًا بين الواقع والمثال، بينما هو كائن وما ينبغي أن يكون، وهذا التوتر هو الذي يصنع الحراك الحضاري، إذ لا تنشأ الإصلاحاتالكبرى من الرضا، بل من الشعور بأن هناك مستوى أعلى لم يتحقق بعد، وهنا تؤدي المهدوية وظيفةالمعيار الأعلى الذي تُقاس به الفجوة بين الحاضر والمستقبل، فتتحول إلى قوة نقدية مستمرة تكشفقصور البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتدفع باتجاه تجاوزها لا باعتبار ذلك تمرّدًا على القدر،بل انسجامًا مع الاتجاه العميق للتاريخ.
أما كونها قوة دافعة لتكامل الشعوب والبشرية فيعني أنها تتجاوز الأفق الطائفي أو الهوياتي الضيقلتطرح صورة عالم تتراجع فيه العصبيات لصالح القانون، وتذوب فيه الامتيازات الوراثية أو الفئوية أمامقيمة الإنسان، وتنتقل فيه العلاقات بين الأمم من منطق الغلبة إلى منطق التعاون، فالمهدوية في هذاالمعنى لا تشير إلى انتصار جماعة بقدر ما تشير إلى نضج البشرية إلى مستوى تستطيع فيه إدارةاختلافها دون تحويله إلى صراع وجودي، وتستطيع فيه بناء الثقة العابرة للحدود والهويات، وهذاالتكامل لا يعني إلغاء التنوع، بل إدماجه في إطار قيمي مشترك يجعل العدالة معيارًا أعلى من الانتماء،وبذلك تصبح المهدوية أفقًا أخلاقيًا عالميًا، حتى لو تجسدت في لغة دينية مخصوصة، لأنها تتحدث عناكتمال إنساني لا عن غلبة فئة.
إن النظر إلى المهدوية بوصفها قوة دافعة للحراك الحضاري يحرر الإيمان بها من السكون، لأن الانتظارهنا لا يعود حالة تعطيل، بل يتحول إلى وعي بالاتجاه العام الذي ينبغي أن يسير فيه الفعل الإنساني، فكلجهد لبناء مؤسسة عادلة، وكل محاولة لترسيخ القانون، وكل سعي لنشر القيم الأخلاقية في الاقتصادوالسياسة والثقافة، يصبح جزءًا من المسار الطويل الذي تقوده تلك القوة المعنوية نحو أفق أعدل،وبهذا المعنى لا تكون المهدوية نهاية العمل، بل بدايته الدائمة، ولا تكون بديلاً عن المسؤولية، بل تعميقًالها، إذ تغدو العقيدة طاقةً تُشعر الإنسان بأنه شريك في حركة الارتقاء الكبرى، لا متفرجًا على حدثمؤجل.
وهكذا تتجلى المهدوية، في بعدها الحضاري، بوصفها المحرك الأخلاقي العميق لمسيرة الإنسان،والطاقة التي تدفع التاريخ إلى تجاوز مراحله الأدنى، والبوصلة التي تشير دائمًا إلى إمكانية عالم أعدل،فتغدو فكرة الظهور رمزًا لذروة هذا المسار لا قطيعةً معه، وتصبح المهدوية اسمًا آخر لإيمان الإنسان بأنالعدل ليس حلمًا مستحيلاً، بل أفقًا تاريخيًا تقترب منه البشرية كلما ارتقت في وعيها وقيمهاومؤسساتها، وبذلك تتحول من عقيدة انتظار إلى فلسفة ارتقاء، ومن خبر عن المستقبل إلى قوة تصنعه.