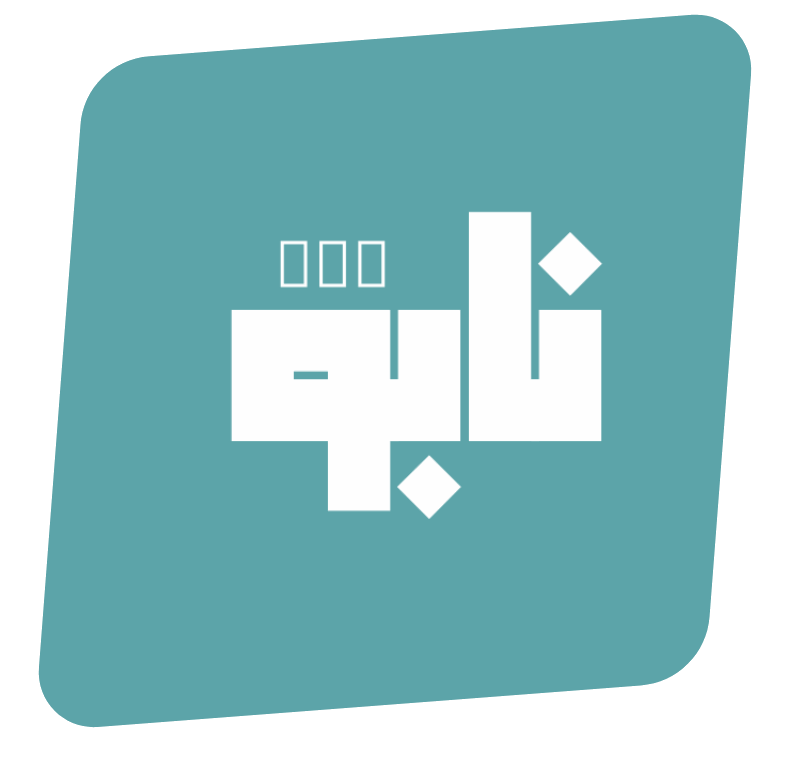محمد عبد الجبار الشبوط
لا يمكن فهم الانتقال من أفق الحداثة المتأخرة إلى الأفق الحضاري إلا عبر تفكيك البنية الداخلية للنموذج الليبرالي نفسه، لا بوصفه خصمًا تاريخيًا، بل بوصفه مرحلة تطورية بلغت حدودها. فالدولة الليبرالية لم تكن انحرافًا في مسار التاريخ، بل كانت استجابة ضرورية لطور إنساني معين، غير أن المشكلات البنيوية التي تكشفها اليوم تشير إلى أن هذا الطور لم يعد كافيًا لاستيعاب مستوى النضج الإنساني والتعقيد الحضاري الراهن. من هنا تظهر الحاجة إلى صيغة دولة مختلفة في منطقها الداخلي، هي ما يمكن تسميته بالدولة الحضارية الحديثة.
الأساس الفلسفي للدولة الليبرالية يقوم على الفردانية التعاقدية، حيث يُفهم المجتمع بوصفه مجموع أفراد مستقلين يسعون إلى تعظيم مصالحهم، وتقوم الدولة بدور المنظّم للتفاعل بينهم عبر القانون. أما الدولة الحضارية الحديثة فتنطلق من تصور مختلف للإنسان، لا بوصفه وحدة اقتصادية قانونية مكتفية، بل كائنًا حضاريًا مركبًا، تتشكل هويته داخل شبكة من القيم والعلاقات والمعنى. هذا التحول في صورة الإنسان ينعكس مباشرة على وظيفة الدولة وطبيعة مؤسساتها.
في النموذج الليبرالي، يُفترض ضمنًا أن الإنسان مكتمل البنية النفسية والسياسية، وأن المؤسسات يجب أن تكتفي بحمايته من الإكراه وتنظيم تعاقداته. أما في الأفق الحضاري، فالإنسان يُفهم بوصفه غير مكتمل، أي كائنًا قابلًا للارتقاء الأخلاقي والمعرفي والوجداني. هذا اللااكتمال الأنثروبولوجي يجعل من الدولة إطارًا مساعدًا على النمو، لا مجرد حارس للنظام القائم. هنا تنتقل غاية الدولة من إدارة التنافس بين المصالح إلى ترقية الحياة الإنسانية ماديًا ومعنويًا.
ينعكس هذا التحول بوضوح في مفهوم الحرية. فالليبرالية تركز على الحرية السلبية، أي غياب الإكراه، بينما يُعاد تعريف الحرية في الدولة الحضارية بوصفها حرية إيجابية مسؤولة، تعني القدرة على الفعل الأخلاقي المنتج داخل شبكة اجتماعية. وبذلك تصبح المسؤولية جزءًا من البنية المؤسسية والقيمية العامة، لا شأنًا فرديًا خاصًا.
القيم في الدولة الليبرالية تُترك للمجال الخاص أو الثقافي، حرصًا على حياد الدولة، أما الدولة الحضارية فتعترف بأن أي نظام سياسي يقوم فعليًا على منظومة قيم، وتعمل على جعل هذه القيم — كالعدالة، والثقة، والتعاون، والإتقان، والسلام — بنية تأسيسية للنظام العام، دون أن تتحول إلى أيديولوجيا مغلقة. وظيفة القانون تبعًا لذلك لا تقتصر على تنظيم التعاقد وحل النزاعات، بل تتسع لتوجيه السلوك العام ضمن أفق حضاري يوازن بين الحرية والمصلحة العامة.
في المجال الاقتصادي، يقوم النموذج الليبرالي على سوق حر يحدد التوازنات، بينما يُفهم الاقتصاد في الدولة الحضارية بوصفه نشاطًا إنسانيًا يجب أن يندمج في منظومة القيم ويخدم الارتقاء الإنساني، لا أن يتحول إلى قوة عمياء تعيد تشكيل المجتمع وفق منطق الربح وحده. وينطبق الأمر نفسه على العلم والتقنية، اللذين لا يُنظر إليهما كأدوات حيادية فقط، بل كقوى ينبغي ضبطها أخلاقيًا ضمن رؤية إنسانية شاملة.
يتبدل مفهوم المواطنة كذلك؛ ففي الدولة الليبرالية هي صفة قانونية متساوية، أما في الدولة الحضارية فهي انتماء قانوني يتكامل مع مشاركة قيمية في مشروع حضاري مشترك. العدالة لم تعد عدالة إجرائية وتوزيعية فحسب، بل عدالة مركبة تشمل البعد الاجتماعي والحضاري، وتُقاس بقدرة المجتمع على تمكين أفراده من النمو لا مجرد حمايتهم من الظلم.
من حيث العلاقة بين الفرد والجماعة، تمنح الليبرالية أولوية واضحة للفرد، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفكك الروابط الاجتماعية، بينما تسعى الدولة الحضارية إلى توازن عضوي يحفظ الفردية دون أن يقطعها عن الجماعة. أما في ما يتعلق بالمعنى، فالدولة الليبرالية تعلن حيادها القيمي، لكنها عمليًا تترك فراغًا وجوديًا، في حين تعمل الدولة الحضارية على رعاية الإطار القيمي العام دون فرض رؤية أيديولوجية محددة.
هكذا يتغير مفهوم التقدم ذاته؛ فبدل أن يُختزل في النمو الاقتصادي وتوسيع الحقوق، يُفهم بوصفه نموًا إنسانيًا شاملًا في الوعي والأخلاق والعلم والعلاقات. الشرعية لم تعد تقوم فقط على الإرادة الانتخابية والعقد الاجتماعي، بل تتكامل مع ما يمكن تسميته بالشرعية الحضارية، أي قدرة الدولة على تحقيق شروط الارتقاء الإنساني.
بهذا المعنى، تمثل الدولة الليبرالية مرحلة أساسية في مسار الحداثة، لكنها ليست نهايته. مشكلتها الكبرى ليست في مبادئها، بل في حدودها البنيوية التي تؤدي إلى الفردانية المفرطة وأزمة المعنى وتآكل الثقة. أما الدولة الحضارية الحديثة فليست نقيضًا لها، بل تجاوزًا لها من الداخل، يدمج منجز الحرية في أفق أوسع يجعل من الدولة إطارًا لارتقاء الإنسان لا مجرد جهاز لتنظيم الواقع.
إن الانتقال من الدولة الليبرالية إلى الدولة الحضارية الحديثة ليس انقلابًا أيديولوجيًا، بل تحوّل في فلسفة الدولة ذاتها: من دولة تنظّم الإنسان كما هو، إلى دولة تبني مؤسساتها على أساس الإنسان كما يمكن أن يصير. هنا يبدأ الأفق الحضاري، لا بوصفه حلمًا طوباويًا، بل استجابة تاريخية لمرحلة جديدة من نضج الإنسان.