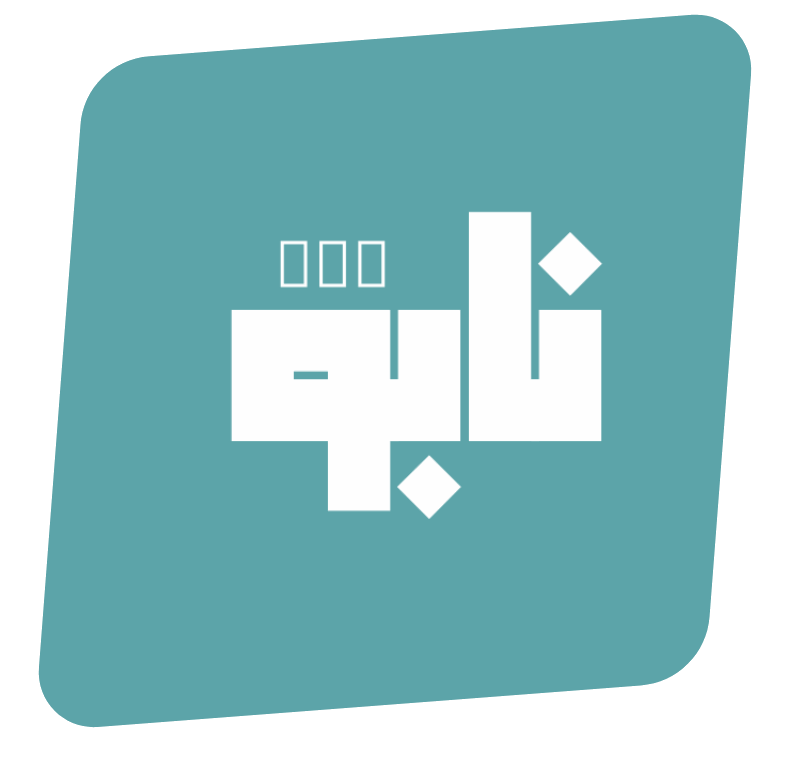د. طالب محمد كريم
يعتقد كثيرون أن مسألة الوعي معقّدة بذاتها، لكنهم نادراً ما يسألون: أيّ وعي نقصد، وأيّ وعي نرجو؟ فالوعي ليس كياناً واحداً متجانساً، بل مسارات وسياقات متعدّدة، لكلٍّ منها شروطه وحدوده وأفقه في الفهم. نحن، في الحقيقة، أمام وعيات لا وعياً أحادياً.
من هنا، لا تكمن الديناميكية في البحث عن وعي واحد جامع، بقدر ما تكمن في الاعتراف بتعدّد الوعيات، وفي فهم كيفية تفاعلها وتجاورها وتصادمها أحياناً. غير أن ما نبتغيه ضمنياً ليس هذا التعدّد لذاته، بل سياق تفاهمات يتيح لنا الحركة داخل مساحات الحياة من دون إعاقات رمزية أو حواجز إقصائية تُضيّق الحريات، وتحوّل الاختلاف من شرط للتعايش إلى مانع منه.
عند هذه النقطة، نتقاطع مع فولتير حين انتقد أولئك الذين اختزلوا التاريخ في سرديات الحروب، والممالك، والإمبراطوريات، متجاوزين صُنّاع التاريخ الحقيقيين: المبدعين، والمنتجين، والعلماء، وبناة الحياة اليومية. فالتاريخ، في جوهره عنده، ليس أرشيف صراعات فحسب، بل سجلّ القدرة على إنتاج المعنى والعيش الكريم.
غير أن الشعوب المتأخرة، بدل أن تُراجع هذا الخلل، غالباً ما تغرق في مخيّلات تعويضية، تُضفي على ذاتها عناوين كبرى لا تعكس واقعها، بقدر ما تكشف عن أمراض نفسية جمعية: خوف من المجهول، وضعف أمام الفعل، وعجز عن مواجهة الأسئلة الحقيقية. وليس واضحاً ماذا منحتهم هذه المخيّلات من تعليم جيّد، أو نظام صحيّ يلبّي حاجات الإنسان، أو حياة كريمة تُقاس بالفعل لا بالشعارات.
نتحدّث عن حضارتنا، فيما نعجز عن توفير مصابيح ليلية تُنير دروبنا. ونتحدّث عن الحوكمة والحكومة الإلكترونية، بينما لا تزال أبسط مراجعة إدارية تتطلّب حقيبة من الأوراق، حرقاً للزمن، ومضاعفة للجهد، وتبذيراً للمال العام.
نتكلّم عن الرفاهية، في وقت تكبر فيه المشكلات بدل أن تتقلّص، نموٌّ سكانيّ متسارع يقابله عجزٌ سكنيّ، وتتمدّد العشوائيات بوصفها حلّاً اضطرارياً للفشل المؤسسي، لا ظاهرةً عابرة. وهكذا يتّسع الخطاب ويتقلّص الواقع، وتتراكم الوعود فيما تتآكل شروط الحياة الكريمة.
في المحصّلة، لا يكمن النجاح في كثرة الشعارات ولا في تضخيم الخطابات، بل في ضبط خرائط الفكر وإخضاعها للعلمية والمراجعة المستمرة. فكم من حروب شُنّت على النتاجات العلمية، وكم من عوائق وُضعت في طريق المعرفة، ومع ذلك كانت الجولة، في النهاية، لمنطق الفكر لا لضجيج السلطة.
غير أنّ المفارقة المؤلمة تظهر بعد انقشاع الغبار، حين نقف أمام حقيقة مرّة: كم كانوا بيننا، عاشوا وغادروا الحياة وهم محرومون من معرفة الحقيقة، لا لقصور في عقولهم، بل لأن الحقيقة حُجبت عنهم. وكم قُتل أناس دفاعاً عن فكرة، ثم تبيّن لاحقاً أنها وهمٌ صيغ بعناية، ووُظِّف لإدامة الهيمنة وتبرير السلطة.
عند هذه النقطة، لا يعود السؤال: من انتصر؟ بل: كم كان ثمن هذا الانتصار من إعمار ، ووعي، وفرص ضاعت لأن خرائط الفكر لم تُراجع في وقتها.