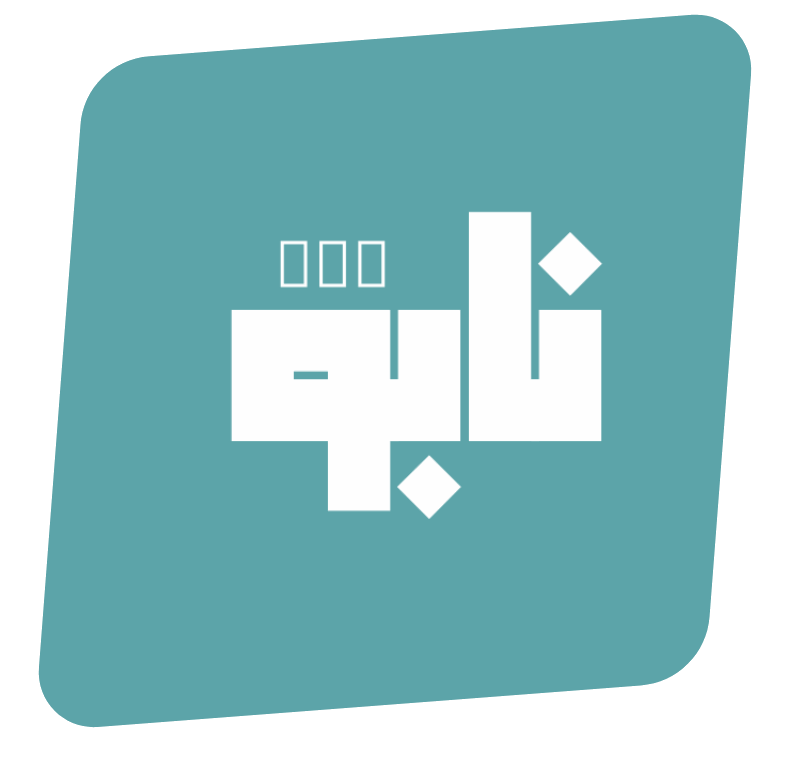في السياسة، لا أحد يظل في موقع العدو إلى الأبد، تمامًا كما لا أحد يحتفظ بمكان الحليف إلى الأبد. ما يبدو صراعًا أخلاقيًا في أعين الجمهور، يكون في الكواليس مجرد ملف مؤقت، ينتظر لحظة مناسبة ليُعاد فتحه أو إغلاقه أو إعادة ترتيبه بالكامل. الأسماء تُعاد تسميتها، والصفات تُعاد صياغتها، والخصوم – حين تحين اللحظة – لا يُستأصلون، بل يُعاد توظيفهم.
العداوة هنا ليست حكمًا أخلاقيًا، بل حالة سياسية قابلة للتعديل. الخصم لا يُصنَّف لأنه ارتكب ما لا يُغتفر، بل لأنه في تلك اللحظة، لم يكن قابلًا للاستيعاب. فإذا ما تغيّرت الشروط، وتبدّلت خارطة المصالح، أمكن للعدو أن يعود إلى الصورة، ولكن بشكل جديد. ما كان يُرفض بشدة بالأمس، قد يُستدعى اليوم كشريك ضروري. لا لأن شيئًا تغير في جوهره، بل لأن مكانه في اللعبة أصبح متاحًا.
هذا ما يمكن تسميته بالترويض السياسي. وهو لا يعني التصالح، بل الإدماج المشروط. لا يقوم على الغفران، بل على توظيف الخطر بعد ضبطه. من كان يُحارب يُستبقى، لا ليرتقي، بل ليُستخدم. الشرعية هنا ليست نتيجة لطهر أخلاقي، بل لكفاءة وظيفية. السياسة لا تكافئ النقاء، بل الانضباط. ومتى ما أصبح “العدو” قابلًا للتحكم، يمكن إعادة تقديمه إلى المسرح دون تبرير طويل.
في هذا السياق، لا يُمحى التاريخ، بل يُجمَّد. لا تُغلق ملفات الإدانة، بل تُعلّق، تمامًا كالقنابل المؤقتة، جاهزة للتفجير عند أول انحراف عن النص. فالدولة لا تنسى، لكنها تتغافل متى ما اقتضت مصلحتها ذلك. وما يُحفظ في الأدراج ليس بغرض الأرشفة، بل للاستخدام المستقبلي إن دعت الحاجة.
المفارقة الأكثر إثارة للسخرية أن من يعود إلى الطاولة ليس مجبرًا على الاعتذار، ولا على تفسير ماضيه. يكفي أن يغيّر زاوية وقوفه، ليُعاد تقديمه بلغة جديدة. المذنب لا يمر بمرحلة تنقية، بل يعبر عبر ممر مختصر اسمه “البراغماتية”. والمشكلة ليست في التحول، بل في سرعة تصديق الجمهور له، ما إن تصدر الإشارة من أعلى.
وما يغيب عن كثيرين، أن الترويض ليس نهاية للصراع، بل بداية لدور جديد فيه. فالخصم السابق لا يتحول فجأة إلى ملاك، بل يصبح عنصرًا منضبطًا في ماكينة الحكم. يُعاد تشغيله من الداخل لا من الخارج، ليؤدي وظائف لم يكن مناسبًا لها من موقعه السابق. وهكذا، لا يختفي الخطر، بل يُعاد تغليفه بعلامة جديدة، ويُقدَّم كسلعة أكثر قبولًا في السوق السياسية.
حين ينقلب العدو إلى شريك، لا يعني ذلك أن الحقيقة تغيّرت، بل أن زاوية النظر تغيّرت. من كان مهددًا للأمن يصبح ضامنًا له، ومن كان خطرًا يُعاد تقديمه كحل. لم يتغيّر الرجل، بل تغيّر موقف القوى الكبرى منه. ومتى ما وُقّعت الصفقة، يُعاد تشكيل الصورة، ويبدأ خطاب جديد يتحدث عن “الواقعية” و”الفرص”، وكأن ما سبق لم يكن.
هنا تتضح القاعدة التي أدركها ميكافيلي مبكرًا: ليس على الحاكم أن يعاقب جميع خصومه، بل أن يعرف من منهم يمكن الاستفادة منه. التهديد لا يُقابَل دائمًا بالقوة، بل أحيانًا بالترويض الذكي. والحكم لا يُبنى على من هو الأصدق، بل على من هو الأقدر على تنفيذ المطلوب.
ولعل ما يجري هذه الأيام في المنطقة، يقدّم نموذجًا حيًا لهذا المنطق البارد. حين يُفتح الباب فجأة أمام من كان قبل سنوات قليلة هدفًا للملاحقة والتصنيف، وتُمدّ له اليد باسم الاستقرار، لا نحتاج إلى شرح طويل لفهم أن السياسة لا تمشي في خط مستقيم، بل تدور كما تدور المصالح.
في نهاية المطاف، السياسة لا تبرئ أحدًا، ولا تلعن أحدًا إلى الأبد. هي فقط تضع الناس حيث يخدمونها أكثر. ومن يعود إلى الطاولة، لا يعود لأنه أصبح بريئًا، بل لأنه أصبح مفيدًا.